تحرص إبنتي وصال، تلميذة السنة الأولى أساسي على تنفيذ كل ما تطلبه منها معلمتها، كأنه امر عسكري من أحد الجنرالات المشرفين عليها، لا جدال فيه. وهي ترغب من وراء ذلك أن تحافظ على ترتيبها الأوّل في القسم من حيث النتائج.
تناقش كل ما يعرض عليها وفي تنفيذ ما يطلب منها. وتكثر من الأسئلة ولا يهدأ لها بال حتى تحصل على إجابة تشفي شغفها، حتى وإن اضطرت إلى التوقف على تناول طعامها الذي لا تكثر منه كأنها عارضة أزياء لبنانيّة ملتزمة بحميّة.
“الحلزون” هو الحيوان الذي اختارت وصال هذه المرة أن تبحث في أمره وتجلبه الى المعلمة في حصة الايقاظ العلمي. لم يكن الحلزون موجودا في الأسواق بسبب تأخر نزول المطر. وبالتالي كان علي أن أتدبّر أمري مثلما فعلت المرّة الفارطة مع الأرنب. وهذا التزام منّي بصفتي أبا وأيضا خوفا من غضب وصال وذلك مراعاة للصلة الطيبة بيني وبين ابنتي التي قضيت سبع سنوات من اللعب معها.
عندما طلبت منها المعلمة إحضار أرنب، لم يحالفها الحظ بسبب عدم حضورها طيلة أسبوعين بالمدرسة نتيجة اصابتها ب”الزوقار” وهو مرض جلدي يصيب الصغار ويحتاج الى راحة وعلاج بالمراهم. وبالتالي لم نجد بدّا من ذبح الأرنب الذي تكلف أكثر من عشر دولارات. وقد كان مذاق الارنب طيبا على طاولة الطعام رغم رفض وصال لذبحها وللأكل منها مصرّة أن الارنب كائن مسالم لا يجب أن يذبح، دون أن تعلم أن في قانون الغاب المسالم هو من يؤكل…مثل الحلزون تماما.
الحلزون اختارته وصال على اعتبار أنه حيوان أليف تماشيا مع البرنامج المدرسي. وفي ظل تقصيري الشديد في اللعب مع وصال والتنزه معها، فإن مرافقتها في رحلة البحث صارت واجبا لا مناص من التمادي في التنصّل منه بحجة العمل الصحفي الذي ابتلع وقتي وجهدي وأوقات المرح مع أطفالي.
أصبح مؤكدا أن شقيقها محمد أمين لا يرضى مفارقتها في معظم هذه الاستطلاعات الشيقة والشقية. علاوة على اللعب معها وزيارة ابني عمها في منزل جدهما بحي المنشيّة الذي تربيت فيه. هناك حيث الذكريات مزيج من الشقاء والشقاوة. 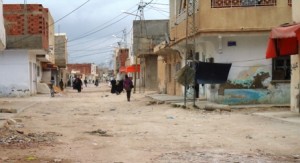
كان علينا ان نبحث عن الحلزون. الكميات قليلة، ولكن الصديق عبد الفتاح صاحب مزرعة انتاج الحلزون، الذين استنجدت به ليسعفني ببضع “حلزونات” كما تسميها وصال، كان كريما إلى أبعد الحدود وأهدانا كميات طالبا مني ان أتذوق طبقا من أكلة الحلزون خاصة وأنه سبق وحدثني عن فوائد الحلزون الغذائيّة. عبد الفتاح صاحب مشروع تربية الحلزون ولديه مؤسسة قائمة بمنطقة “زميط” غرب مدينة القيروان وقد سبق له أن درس علوم الاحياء وبقي معطلا عن العمل ثم اختار بعث مشروع خاص…تربية الحلزون.
لم تكن الرحلة بعيدة ولكن جعلنها طويلة ببعض الاضافات والوقفات فكانت رحلة سياحيّة فيها من التشويق والاثارة ما يقطع مع الروتين اليومي.
وسيلة تنقلنا العاديّة هي الدرّاجة الناريّة التي أتنقل عليها في تحقيقاتي الصحفيّة بما في ذلك البعيدة.
وضعت وصال قبعة للاتقاء من حرارة الشمس الحارقة. في حين خير محمد أمين وضع نظارات شمسية ليتفادى أشعة الشمس التي اعتصمت في قلب الظهيرة.
الصغير وهو يستعجل الرحلة بشغف، لم يجد نظارته الشمسية فأخفى عينيه العسليتين بنظارات والدته السوداء. لم يكترث هو بالفارق وأنا بدوري لم أهتم بالمسألة. الغاية في الأخير تبرر الوسيلة. ليس دائما لكن هذه المرّة نحن سنتوغل في أماكن ريفيّة خالية من مراقبة الناس، الا قليلا.
وان يكن ماذا تنفع نظرات الفضول وبماذا تضرّ…لا شيء في هذا العالم المتحرّك المليء بالإرهاب والصخب .
كان محمد أمين متحفزا للرحلة بشكل يخالف خجل وصال التي لا تريد أن تضحك كثيرا لكي لا يبرز تأخر نمو أسنانها القواطع. في الحقيقة أنا من نزعتها دون ألم بعد طول انتظار ومتابعة رغم رفضها، لكن الخيط الرفيع الذي نتراهن على تنفيذ المهمة في محاولة واحدة كان يخدعني إلى أن راوغتها مرة وسبق الخيط بكاءها.
أثناء المرور من مفترق الطريق الحزاميّة، ضاعفت من الانتباه رغم وجود دوريّة لشرطة المرور. انشغال الأعوان بالحديث ومرافقتي لطفلين جعلاني التفت مرارا خشية انفلات سيارة مجنونة خصوصا بعد متابعتي اليومية لحوادث المرور القاتلة.
الله لطيف ستّار.
جزء من الانشغال والالتفات المتكرر جعل أنظاري تنزلق أسفل القنطرة القديمة فوق وادي مرق الليل الذي أذكر وأنا طفل أنه ابتلع عديد الأطفال. فقد كان الأطفال في الحي المجاور للطريق الحزامية يسبحون به ناهيك عن اللعب ورعي الغنم. وقد لعبت فيها كثيرا.
فوق القنطرة القديمة، التي تحولت الى مصب عشوائي للفضلات وأسفلها بركة مائيّة، لفت انتباهي وجود أربعة نسوة منهن امرأتان عجوزان. النسوة وزعن الأدوار بينهن في عمل لا أدري ما الذي دفعهن اليه تحت حرارة الشمس الحارقة خاصة وأنه لا يدر الكثير من المال.
لقد ذهب في ظني في البداية أنهن يغسلن الصوف على ضفاف الوادي خاصة وانا انظر الى بركة المياه أسفل القنطرة كما أن حركاتهن تحاكي عمليّة دق الصوف ونثره وغسله. ولكن عند تدقيق النظر وصلت الي صورة مهينة. ولقد هممت بعدم الرجوع اليهن لكن تبين أن النظرات الاولى خداعات.
وما أكثر الخدع في موطني قبل الثورة وبعدها.
الشغل الذي كان بين أيديهن هو دق كدس من رؤوس نبتة شوكيّة توجد بداخلها حبات سمراء كنا نسميها “قمّيح” وتسمى مجازا “زقوقو” نظرا لتشابهها مع حبات “الصنوبر الحلبي” الذي يستعمل في تونس لطبخ العصيدة.
حدثنني النسوة عن عملهن وأرباحهن القليلة. لكن واحدة منهن خيرت عدم الحديث أمام الكاميرا وهي أصغرهن سنّا.
عجوز تبلغ من العمر خمسة وسبعين سنة، كانت تدق كومة من اللون الأبيض سمته ريشا. لم تكن تقوى على الوقوف فاتكات على عكاز هو عبارة عن هراوة غليظة.
حدثتني العجوز عن ظروف عملها تحت الحر ومرضها المزمن الذي يحتاج الى تحاليل وحاجتها الى المال. كانت مضطرة لهذا العمل لجمع بعض المال.
تركت أمر وصال بضع دقائق تحت الشمس وأجريت تحقيقا. وقد تبين لي انهن عائلة واحد يشتركن في نفس العمل لكن لكل امرأة منهن “كدس” مخصوص.
المرأة المسنة الثانية التي قالت ان عمرها خمسا وستين عاما، بدت لي أكبر سنا خاصة وهي تظهر فمها الخالي من الاسنان. ولكنها أخبرتني أن أسنانها تساقطت بسبب مرض السكري المزمن.
تحت أشعة الشمس الحارقة، ودون حاجز أو واقي، كانت حركتهن تفوق السكنات كأنهن في صراع مع الوقت أو أن الحرفاء ينتظرون. تدق هذه الكومة وتذر الأخرى الريش. وتشعل إمرأة أخرى النار، أمّا التي رفضت الحديث فكانت منشغلة بتنقية كميات قليلة من “شعير المرمز” في صمت.
تجني النسوة ربحا قليلا جدا لا يتجاوز الدينار الواحد لكل واحدة منهن في اليوم الطويل من العمل المظني، ولكن تعاون بعض الحرفاء معهن شجعهن. كما أن حاجة عائلتهم للمال دفعتهن للخروج والبحث عن حلول عجز الرجال عن ايجادها لأسباب صحية أو اجتماعية يعلم الله حقيقتها ولكن الحقيقة ظاهرة.
زادهن من الطعام، لا يتجاوز قارورة ماء مهملة تحت شمس منتصف نهار حار. تغطي وجوههن شعيرات الريش الابيض. ايديهن انتفخت من وخزات الاشواك ولسعاتها حتى شبهتها العجوز المسنة بالعقارب.
كان الدرس الاول لوصال، التي حصلت على بعض الحبات هديّة من الكريمات الباحثات عن كرامة تائهة، ثمار عرق النسوة، هي أن ربح المال يتطلب التعب والتضحية رغم ان وصال كانت بقبعتها ومحمد أمين بنظارته المزيفة، يبدوان مثل برجوازيين من عائلة برجوازية متعفنة تتحدث عن العدالة الاجتماعيّة والمساواة من وراء السيارات الفارهة ومن شرفات القصور…الحقيقة أن حياتهما بسيطة وأنا من يدرأ عنهما متاعب الحياة وقسوتها. وهذا واجبي وحلمي.
رغم الألم والوجع والحسرة، لم تفسد الرحلة، عبارات الحمد تعالت على ذكريات الطفولة أيّام كنت انا نفسي أجمع تلك الحبّات بجهد وجروح وأبيعها بأبخس الاثمان وكنا حفاة عراة في صورة أقرب الى حالة أولئك الكريمات.

في طريقنا الى حديقة الحلزون استوقفتنا الطبيعة الخلابة في أكثر من مناسبة. تعودت أن التقط الصور لوصال ومحمد أمين ولكن قررت أن أقف أمام الكاميرا هذه المرّة وكانت وصال هي من صورني، وقد اكتسبت بعض التجربة بفضل ثقتها في نفسها وتعودها على مسك الكاميرا. وكنت أغض الطرف عن لعبها بها هي وشقيقها.
حقول القمح والشعير والقصيبة تتعالى زهوا بثقل الحبات المتمايلة مع نسمات الريح. اصفرار بعض السنابل نافس خيوط الشمس في اللمعان.
هذه زرعها الفلاح، يقول محمد أمين الذي يعتبر أن الفلاح هو أسعد انسان لأن لديه جرّارا. أما وصال فاستنتجت انه بمجرد زراعة الحبوب يجب وضع فزاعات لطرد الطيور. وتساءلت عن حقول الطماطم في حين انتبه محمد أمين الى حقول “النباتات الشوكيّة” التي غزت الأرض المهملة فنافست حقول القمح وقال انها تلك التي كانت النسوة تدقها دقّا لتخرجن منه حبّا…وخبزا.
المسلك الفلاحي المؤدي الى ضيعة عبد الفتاح، هو عبارة عن تراب طيني، من حسن الحظ لم يكن مبللا لأنه كان هناك آثار مسيرة عسيرة لعجلات عربات. فنزول الامطار يغلق السبيل عن سكان منطقة زميط. وقد أغلقوا الطريق مرارا ليلفتوا انتباه المسؤولين، لكن لا آذان تسمع ولا أفئدة تنصت.
المسؤولون يتمتعون بالمنح والحوافز والامتيزات ولا يفعلون شيئا. هذا استنتاجي الشخصي من خلال متابعة الشأن التنموي بالقيروان. شاب رأسي من تلك المسائل.
يريد محمد أمين اصطياد فراشة كانت تحوم من حوله وهو متمسك بالدراجة التي زادت سرعتها في الرجوع الى المسلك الصحيح عندما تفطنت الى أننا لم نكن في الاتجاه الصحيح نحو الحلزون. وفي الطريق يستوقفنا محمد أمين ليشرب من قارورته التي لا يريد لأحد أن يفتحها الا بطريقته الخاصة.
بعد محطات وصور وذكريات مع المزارع والطيور والفراشات والزهور وحتى التين الشوكي وصلنا الى بيت الحلزون. ولقد سلّم الرجل الذي يعمل هناك وصال علبة مليئة بالحلزون الضخم الذي يثير شهية أكله مطبوخا.
يبدو أن وصال خافت من الحلزون وأنا اطلب منها الاقتراب لأخذ صورة وسط الحقل. في حين تمعن محمد امين في حركان الحلزون النسيابيّة، وقد اطمأنت وصال بعد ذلك لعلمها أن الحلزون مسالم أليف. 
في طريق العودة رسمت وصال برنامج عملها لملف الحلزون ونبهتنا الى عدم طبخه من أجل الحفاظ عليه. وذكرتني بالأرنب الذي قالت انه لا يؤكل.
عدنا سريعا بشكل أزعج وصال فطلبت التقليل من السرعة لأن جلوسها خلفي على الدراجة البيضاء آلم ظهرها وهي تهتز بسبب رداءة المسلك الفلاحي.
كان طريق العودة أكثر اختصارا وبدت وصال وهي تلاعب الحلزون أنها حققت اكتشافا وانتصارا على الطبيعة وعلى زملائها في القسم. رغم أن الرحلة لم تتجاوز ساعتين، إلا أنها تركت أكثر من انطباع جميل وكانت وصال مفعمة بالحركيّة ومليئة بالخطوات العمليّة وهي تعد ملفها.
أهم مكسب هو خروجي مع الاطفال في رحلة، ثانيها استجابة وصال لطلب معلمتها وفرحتها بأنها ستحمل الحلزون الذي وعدت به معلمتها، وثالثا محاورة النسوة على الطريق. الطريق الى المعرفة فيه متعة ولكن على الطريق متاعب ومعاناة.
من حسن الحظ فان معاتبة وصال لي لأنني طبخت الحلزون لم تكن طويلة لأنني لم أحسن طبخها ولم نأكلها. ومن حسن حظها أنها ما تزال تحتفظ ببعض الحلزونات كما تسميها . هباء أكرر تصحيح العبارة لها بالقول انها “حلزون” في صيغة الجمع والمفرد…
لا يهم النحو…المهم هو حسن التصرّف مع الاطفال وقد شعرت انني أقترب نحو ذلك.
•



سرد لطيف وباعث على البهجة ، احببت رحلتك بصحبة وصال ومحمد ربى يمتعك بصحبتهم دائما ً..
شكرا هذا من حسن ذوقك وتشجيعك
شكرا هذا من لطفك الف تحية